مختصر كتاب “التجسس والمبادئ: أخلاقيات الاستخبارات السرية”
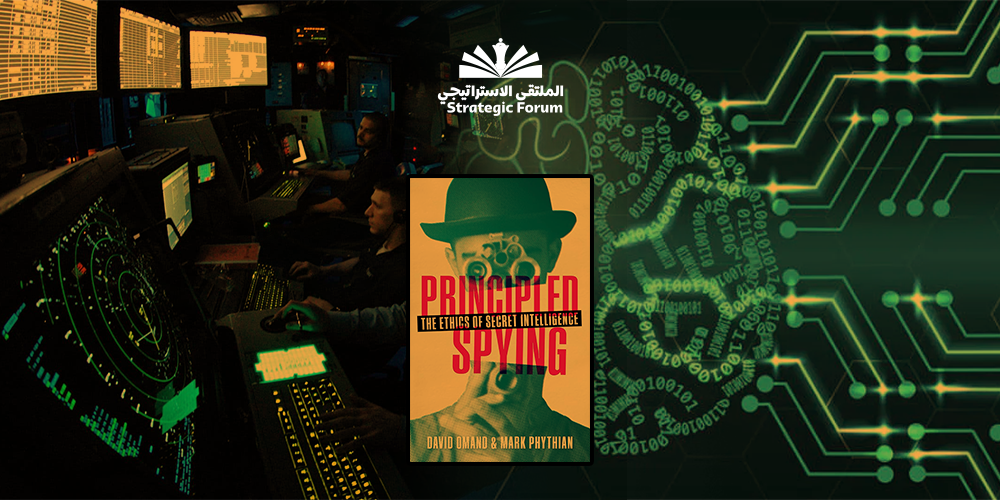
كتبه: ديفيد أوماند ومارك فيثيان
اختصره: أنس خضر
التعريف
هذا كتاب “التجسس والمبادئ: أخلاقيات الاستخبارات السرية”، ألفه الخبير في الاستخبارات والأمن ديفيد أوماند[1] بالاشتراك مع أستاذ العلوم السياسية مارك فيثيان[2]، يناقش دور أجهزة الاستخبارات في “المجتمعات الديمقراطية” والموازنة بين الحاجة إلى الحماية من التهديدات الأمنية والحفاظ على الحريات المدنية، وتمحور حول سؤال مركزي: إلى أي مدى تسمح الدولة لأجهزتها باستخدام طرق استخباراتية سرية دون الإخلال بالحريات؟
يقدم الكتاب دراسة شاملة تأخذ في الاعتبار الاستخبارات الرقمية، وذلك وفق 7 فصول. ويعتمد المؤلفان في كل فصل على حوار وتبادل الأسئلة والأجوبة بينهما بغية تحفيز النقاش والتفكير النشط بدلًا من تقديم مواقف جاهزة، ويستشهدان بوقائع تاريخية مختلفة. لكننا سنركز في تلخيصنا للكتاب على ما يتعلق بالضوابط والمعايير الأخلاقية للحفاظ على الحريات في مقابل الضرورات والأهداف الأمنية والاستخبارية.
العلاقة بين الأخلاق والاستخبارات
لم يكن العمل الاستخباري السري وليد هذا العصر، بل هو عمل قديم في التاريخ يُسهم في تعزيز فهم صناع القرار لمحيطهم الأمني والسياسي لدعم قراراتهم. لكن التساؤلات حول أخلاقيات الأساليب التي تستخدمها أجهزة الاستخبارات تصاعدت في “المجتمعات الديمقراطية” خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا بعد فضائح تتعلق بقضية أسلحة الدمار الشامل في العراق قبل الحرب، وأساليب الاحتجاز والتعذيب التي اتبعت بعد أحداث 11 سبتمبر، والعديد من التسريبات حول المراقبة الرقمية الواسعة.
ولذا، يتساءل الكتاب عن مبررات التعذيب في التحقيق، أو التجسس على قادة دول حليفة، أو مراقبة اتصالات عموم المواطنين وجمع بياناتها، أو استدراج المصادر البشرية عبر العلاقات الجنسية؟
فأجهزة الاستخبارات تواجه خلال عملها معادلة صعبة: فهي تحتاج إلى أساليب للحصول على المعلومات السرية المهمة رغم ما تتضمنه من انتهاكات للحريات، بينما عليها المحافظة على سرية مصادرها وأساليبها كي لا تفقد فعاليتها.
وصولًا إلى الفصل الثالث، يناقش الكتاب العلاقة بين الدولة والاستخبارات والمواطن ومدى التعارض القائم بين واجب حماية الأمن وضرورة احترام القيم الديمقراطية، ثم يدرس حدود ما يجيزه القانون المحلي والدولي من إجراءات استخباراتية، وينتهي بمحاولة تطبيق معايير نظرية “الحرب العادلة”-كالضرورة والتناسب والسلطة الصحيحة والملاذ الأخير- وكيفية استفادة أجهزة الاستخبارات منها عند التخطيط وتنفيذ عملياتها.
وبين الفصول الرابع إلى السادس، يتحدث عن ضوابط تشغيل العملاء البشريين ثم ينتقل إلى استخبارات المصادر التقنية والرقمية، قبل أن يستعرض الآثار الأخلاقية المترتبة على استخدام هذه المعلومات سرًا في الاعتقالات أو توجيه ضربات جوية دقيقة.
أما في الفصل السابع، فيضع المؤلفان معايير الإشراف والمساءلة الضرورية لكسب ثقة الجمهور، ويتحدثان عن كيفية التوفيق بين سرية العمليات وحق المواطنين في المعرفة والشفافية، قبل أن يختما بدعوة إلى تدشين عقد اجتماعي جديد بين الحكومات ومواطنيها وأجهزة الاستخبارات لضمان استمرار استخدام المعلومات السرية في خدمة الأمن دون المساس بالحريات المدنية الأساسية.
مع تنوع التعريفات المقترحة للاستخبارات، نجد أن العمل الاستخباري يتضمن دائمًا تجاوزًا لخصوصية الآخرين وسرقة لمعلوماتهم الخاصة.
من جهة أخرى، تعمل أجهزة الاستخبارات ضمن نظام دولي فوضوي تتوجس فيه كل دولة تجاه نوايا الآخرين؛ ما يُبرر سعيها لاكتساب معلومات حتى عن حلفائها. ففي أوقات الأزمات، يجيز بعض قادة الاستخبارات اعتماد إجراءات استثنائية إن أمكن للمسؤولين الدفاع عنها أمام الرأي العام لاحقًا بالاعتماد على معيار “المصلحة الوطنية”.
عزز انتشار قوانين حقوق الإنسان التعارض بين الضرورات الأمنية وواجبات الدولة تجاه معايير حقوق الإنسان العالمية، وباتت الأسئلة المحورية: كيف نوازن بين مصلحة الدولة والتزاماتها الدولية تجاه الحريات؟ ومن يضع حدود العمل الاستخباري؟ وهل تبرر الظروف الاستثنائية التخلي عن قيم الحريات؟
ينطلق الإطار القانوني لمسار الاستخبارات من الاعتراف بأن التجسّس ارتبط دومًا بالحاجة إلى السرية وباعتماد وسائل تُخالف المعايير الأخلاقية (كالسرقة والرشاوى). وفي مقابل مبدأ “الغاية تبرر الوسيلة”، وضعت نظرية “الحرب العادلة” حدودًا للاستخدام المفرط للعنف وشرّعت مبدأي “الضرورة” و”التناسب” ما مهدّ للعمل وفق مسارات ثلاثة:
- تقييم عواقب نجاح العمليات مقابل مخاطر الفشل أو الفضيحة.
- الضوابط التي أقرها القانون المحلي والدولي لحقوق الإنسان، والتي تحفظ الحد الأدنى من الكرامة والحريات.
- بناء الفضائل الأخلاقية داخل أجهزة الاستخبارات عبر تنشئة ضباط يلتزمون بالشرف المهني والشخصي معًا.
وفي الجانب العملي تبرز قضية تجنيد المصادر البشرية ورعايتهم، ثم ما يتعلق بالثورة الرقمية: إذ تظهر تسريبات أجهزة الاستخبارات مدى انتهاك خصوصيتنا عبر التنصت على تواصلنا وبيانات هواتفنا ومواقعنا، ما دفع الديمقراطيات لوضع تشريعات لحماية “البيانات الشخصية” وتحديد صلاحيات “الاعتراض الجماعي” التي تسمح بجمع كميات ضخمة من المعلومات.
وسط هذا كله، يظل الحديث عن رقابة شفافة ومساءلة دقيقة عاملًا حاسمًا. فالدول الديمقراطية وضعت أُطرًا تشريعية تبيح لأجهزة الاستخبارات العمل ضمن قوانين واضحة وتحت إشراف برلماني أو قضائي.
على صعيد آخر، برزت مع التطور الرقمي فئة استخباراتية حديثة تُسمى “استخبارات البيانات الخاصة- PROTIN”، تستمد معلوماتها من قواعد بيانات شخصية ضخمة- كالسجلات البنكية ومواقع التواصل الاجتماعي وتفاصيل الاتصالات الهاتفية والإنترنت- بموجب أُطر قانونية تمنح أجهزة الاستخبارات شرعية الوصول إليها. وأُضيف إليها ما يُسمى بـ “استخبارات وسائل التواصل الاجتماعي SOCMINT” حين يضطر المحلّل لاجتياز إعدادات الخصوصية للمستخدم. وتزيد هذه التقنيات من المخاوف المتعلقة بانتهاك خصوصية الأفراد عبر التقاط مكالمات عائلية أو محادثات عابرة قد يحتفظ بها المحلل أو يستخدمها رغم عدم صلتها بالتحقيق.
في هذا السياق، نستحضر مبدأ “الضرر الجانبي” في قوانين النزاعات المسلحة، فاحترام خصوصية غير المستهدفين يستلزم تصميم خوارزميات تصفية دقيقة للاقتصار على البيانات الضرورية.
إلى جانب ما سبق، يعتمد عمل الاستخبارات على الإجراءات الوقائية بعد ورود تقارير عن خطر محتمل دون دليل قضائي قاطع، ما يستدعي إجراءات تبدأ من المراقبة المؤقتة وقد تصل إلى الاعتقال.
بناء على هذه المعادلة، يقترح ديفيد أوماند تبني ما أسماه بـ “أخلاقيات المسؤولية” لتشجيع صناع القرار على موازنة الوسائل الأمنية المتاحة لحفظ المصلحة العامة مع تقدير العواقب المحتملة لاستخدام هذه الوسائل من عدمه. بينما يحذر من “أخلاقيات اليقين” التي ترفض أي تنازل عن أي ضوابط أخلاقية وتؤدي إلى تعطيل الإجراءات الأمنية الضرورية رغم تبعات ذلك على حماية المجتمع.
يجد المؤلفان في نظرية “الحرب العادلة” نموذجًا عمليًّا لتقييد النشاط الاستخباراتي أخلاقيًّا؛ فكما لا يُسمح بالقوة المفرطة عسكريًّا فلا ينبغي للإجراءات الاستخباراتية أن تتجاوز ما يتناسب مع تحقيق الهدف الأمني.
وفي الحديث عن الحريات يُطرح تساؤل حول كيفية مساهمة الاستخبارات في تعزيزها لا الإخلال بها، حيث يمكن موازنة حق الخصوصية في إطار “أخلاقيات المسؤولية”، فالتضحية الجزئية بالخصوصية الأسرية مثلًا قد تُبرَّر قانونيًّا وأخلاقيًّا إذا كانت تحمي حق الحياة لطفل مهدَّد. كما أنه من الخطأ حظر صلاحيات مثل الاعتراض الجماعي للبيانات الرقمية في الظروف التي تقتضيها حماية أمن الدولة، شريطة إخضاعها لضوابط تشريعية وبرلمانية صارمة.
من خلال ذلك تنتج لدينا الموازنة بين الكلي والجزئي: فالموازنة الكلية تُحدِّدها السياسات والقوانين الصادرة عن السلطة التشريعية أو الحكومية، وتكون متاحة للرأي العام لضمان الشفافية، فالقانون البريطاني مثلًا يجيز أوامر التنصت الجماعي على الاتصالات فقط إذا كانت مرتبطة بأشخاص خارج بريطانيا.
أما الموازنة الجزئية فتتخذها الوزارات والهيئات القضائية والإدارية في حالة محددة ويُحتفظ بسرية تفاصيلها غالبًا، كالإذن الذي صدر عام 2014 للوصول إلى اتصالات “داعش” في سوريا لمنع مخطط تفجير في أوروبا.
ثم ينتقل النقاش إلى تأثير الثقافة التنظيمية والذاتية في خيارات ضباط الاستخبارات، فتبنّي المنظور المبني على العواقب لا يلغي الحاجة إلى الحكم البشري المتأني في كل حالة.
فعبر مقابلات مع نحو خمسين من موظفي وكالة المخابرات المركزية CIA بعد الحرب الباردة، تراجع “الوضوح الأخلاقي” الذي ساد أثناء الصراع مع الشيوعية إلى حد أصبح بعض المحللين يرون عملهم مجرد خدمة “لمصلحة الولايات المتحدة” لا لمبدأ نبيل، ما يُنذر بالوقوع في “الجوانب القذرة” لمهنة الاستخبارات دون وعي كافٍ بهدف تحقيق أهداف أمنية.
يناقش الفصل بعد ذلك التمييز بين أجهزة الاستخبارات في الدول الديمقراطية ونظيرتها في الأنظمة الاستبدادية، ويستخلص المؤلفان أن الاختلاف الجوهري لا يكمن في التقنيات الاستخبارية المستخدمة، بل في القانون الذي يحدّد مدى ونوعية العمل الاستخباري ويضع ضوابط للمساءلة.
ثم يؤكد أوماند أن أحد الأخطار الأساسية يكمن في “المبالغة في تقدير حجم التهديد”، كأن تُستخدم الصلاحيات الاستخباراتية لتبرير مراقبة خصوم سياسيين أو مواطنين عاديين بما يتجاوز “الضرورة” و”التناسب”. ويخلص المؤلفان إلى أن فعالية الرقابة الديمقراطية عبر إجراءات برلمانية وقضائية مستقلة هي الضمان الحقيقي لحماية القيم الديمقراطية الأساسية وإلا فقد تنحرف أجهزة الاستخبارات من دورها في حماية الدولة والمجتمع لتصبح أدوات قمعية خارجة عن القانون.
وحول التناقض المزعوم بين عمل الاستخبارات في الدولة الديمقراطية، حيث ينتهك عنصر الأمن حريات المواطنين ليحميها، يرفض ديفيد أوماند تصويره كتناقض مطلق بين الأمن والحرية معتبرًا ألا حرية كاملة بلا أمن يحميها، ولا أمن بلا تضحيات جزئية للخصوصيات. لكن السؤال هنا: من يحدد “الحد المسموح” لهذا الانتهاك؟ ومن يراقب أجهزة الاستخبارات؟
دور القانون في ضبط عمل الاستخبارات
خلال العصور الوسطى في أوروبا، ساد “الحكم الملكي المطلق” الذي يعطي للحاكم وحده سلطة إصدار الأوامر السرية وتمويلها بعيدًا عن الرقابة التشريعية، واستخدام الاعتقال والتعذيب لحماية مملكته. ومع صعود البرلمانات في القرن 17، وُلِد “نموذج الحارس الخفي” الذي يقر فيه المشرّعون علنًا بضرورة وجود جهاز أمني سري يرصد ويوفر المعلومات بعيدًا عن الرأي العام، شريطة أن يُموَّل من الخزينة العامة ويخضع لرقابة مالية ضيقة عبر أموال “الخدمة السرية” أو لجان مختارة في البرلمان دون الكشف عن تفاصيل العمليات.
على مدى القرنين التاليين، تطوّرت أجهزة استخبارات مدنية وعسكرية في بريطانيا والولايات المتحدة مستفيدة من هذا التوازن الدقيق بين السرية المطلقة والرقابة البرلمانية الضمنية. غير أن غياب المساءلة والشفافية أتاح لـ “الحراس الخفيين” -أي أجهزة المخابرات- هامشًا واسعًا للعمل أحيانًا استنادًا إلى مخاوفهم من التهديدات السرّية، فظهرت موجات من الملاحقات السياسية والتجسّس المفرط هددت بتحويل أجهزة الاستخبارات إلى نخبة تحتكر المعلومات وتنتهك القانون والحريات.
بعد الحرب العالمية الثانية، بدأت في الولايات المتحدة الهيكلة القانونية للعمل الاستخباري بموجب قانون الأمن القومي لعام 1947 الذي أنشأ مجلس الأمن القومي ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، ثم جاء قانون وكالة الاستخبارات المركزية لعام 1949 ليعفيها من معظم القيود على استخدام الأموال ويخفي تفاصيل بنيتها وعملياتها. ووضع الكونغرس لاحقًا ضوابط لأنشطة أجهزة الاستخبارات والأمن وفق ما يمكن تسميته بـ “نموذج الامتثال القانوني”، الذي يستند إلى تشريعات واضحة وصلاحيات محددة وإشراف قضائي مستقل، في حين أُنشئت محكمة مراقبة التجسس الأجنبي (FISA) عام 1979 لمتابعة أوامر اعتراض الاتصالات.
أما في المملكة المتحدة، فقد جُددت في خمسينيات القرن الماضي توجيهات وزارة الداخلية لمنع اعتراض الاتصالات إلا للجنايات الخطيرة، ونُقلت مسؤولية جهاز الأمن إلى وزير الداخلية واقتصر اللجوء إلى عمليات الاعتراض على حالات الضرورة الملحة بعد فشل الوسائل الأخرى. لكن العمليات بقيت خارج إطار الحصانة التشريعية حتى أواخر الثمانينيات، حين أُجبرت بريطانيا نتيجة فضائح أجهزتها الاستخبارية على سن قوانين اعتراض الاتصالات وعمليات الاستخبارات الأخرى والقوانين التنظيمية للتحقيقات.
ومع تقدم التقنيات الرقمية، بدأت مصادر استخباراتية ضخمة تحصل على بيانات شخصية للأفراد عبر الإنترنت والأجهزة المحمولة، من تتبع حركة الهواتف إلى اعتراض حركة بيانات الإنترنت وعمليات الاختراق. واستخدمت أجهزة الأمن والاستخبارات هذه الصلاحيات بموجب إطار قانوني أُعيد تفسيره سرًا ليتوافق مع التطور الرقمي الجديد. وعندما كشف إدوارد سنودن[3] عام 2013 عن حجم وبرامج التنصت الرقمية الأمريكية والبريطانية، أجبرت الفضائح الحكومات على إطلاق تحقيقات تشريعية وأدت في بريطانيا إلى إصدار “قانون سلطات التحقيق 2016”.
كما تطور ما يُعرف اليوم بنموذج “العهد الاجتماعي” للعمل الأمني والاستخباراتي الذي ينص على: نقاش عام يضفي الشرعية على استخدام الأساليب الاستخبارية السرية، ويحدد الأهداف المشروعة، وينظم أدوات المراقبة التفصيلية، ويُنشئ رقابة مستقلة من مفتشين قضائيين ولجنة برلمانيين، مع محكمة متخصصة للنظر في دعاوى إساءة الاستخدام. وتبنّى الرئيس الأمريكي أوباما خطوات مماثلة بما يوازن بين السرية الضرورية وشرعية الرقابة.
يؤكد ديفيد أوماند أن استحضار هذه المراحل التاريخية يفضح عجزًا ديمقراطيًّا متراكمًا حين كانت أجهزة الاستخبارات تعمل خارج نصوص قانونية واضحة، ما خلق مساحات معزولة من التدقيق الخارجي وفجوة بين الدولة والمواطن. فالسرية ليست فقط شرط فاعلية، بل تمنع إشراك الاعتبارات الأخلاقية في تقييم ما يفعله المحللون والساسة. حيث تظهر ملفات جهاز MI5 البريطاني عن الشيوعيين البريطانيين تقارير اعتمدت جمع معلومات تافهة دون معرفة الحاجة لها، ما يؤكد ضرورة وجود ضوابط للعمل الاستخباري ووقف الاعتماد التلقائي على التفويض القانوني وحده.
من جهته، يؤكد مارك فايثيان أن الساسة غالبًا ما يلجؤون إلى القول “إنه قانوني” لمنع أي نقاش حول أخلاقية العمل الاستخباراتي، معتبرين أنه لا حاجة للسؤال عن الخطأ من الصواب لمجرد شرعية القانون.
لكن القانون وحده لا يكفي لضمان صوابية العمل، بل يجب الجمع بين الاعتبارات القانونية والأخلاقية والسياسية عند ترخيص عمليات المراقبة السرية مع وجود هامش للتقدير الأخلاقي يتجاوز الحدود القانونية. فكلما تطورت الأدوات والتقنيات يصبح من الضروري إعادة طرح السؤال الأخلاقي عن التناسب والضرورة والخصوصية، لا الاكتفاء بالقول “هذا إجراء قانوني”.
ففي نموذج “العهد الاجتماعي”، تخلو القوانين من الغرابة والتعقيد ويسهل تفسيرها على الرأي العام، وتتناغم الأخلاقيات المتعارف عليها في المجتمع مع هذا القانون. ويشير مارك فايثيان إلى اكتساب الإجراءات الاستخباراتية شرعية أكبر عندما تستند أيضًا إلى قواعد قانونية دولية.
على صعيد آخر، يطالب فايثيان بضمان وجود حد أخلاقي واضح لا يتجاوزه عناصر الاستخبارات، رغم الإعفاءات القانونية الصريحة لأعمال مثل الخداع والرشوة والهويات المزيفة. فحتى عندما يسمح القانون لضباط الاستخبارات باستقبال معلومات مُستخلصة بواسطة العنف، إلا أن الحق المطلق في عدم التعذيب يُلزم كل فرد في جهاز الاستخبارات بالامتناع عن المشاركة المباشرة في مثل هذه الممارسات.
ويتطلب الأمر أيضًا تبني جهاز الاستخبارات آليات للتحقق من مصادر المعلومات، فالتدقيق المستقل في الاعترافات والشهادات وحظر الطلب المباشر لمعلومات منتزَعة بالتعذيب وإعداد ملخصات أخلاقية لقضاة مختصين، جميعها وسائل تؤكد أن المشروعية القانونية لا تكفي وحدها لمصداقية العمل الاستخباراتي.
أما في حالات الطوارئ القصوى، يمكن للبرلمان تفويض إجراءات استثنائية محدودة زمنيًّا عبر إشراك قضاة مستقلين في إصدار الأوامر، بما يضمن عدم تحوّل حالة الطوارئ إلى حالة دائمة بلا رقابة.
في أعقاب أحداث 11 سبتمبر، اعتمد ضباط وكالة المخابرات المركزية على ما يشبه الحصانة الرسمية التي يوفرها لهم القانون من الملاحقة والمساءلة الأخلاقية، وبرروا أساليب التعذيب بكونها “تقنيات استجواب معزَّزة” وجعلوها قانونية بالكامل، وصرح بعضهم بأنهم “لعبوا على الحافة القانونية”.
خلقت هذه الممارسات بيئة لا تُعرَف فيها الحدود الأخلاقية بوضوح، بل تتغير بقرارات إدارية تستفيد من السرية وصعوبة المحاسبة. ومن يلجأ إلى استغلال هذه الثغرات القانونية يضمن صعوبة مساءلته لاحقًا. وهذا ما يضع مسؤولية كبرى على هيئات الرقابة المستقلة التي يجب أن تتصدّى لقوى السلطة التنفيذية، وتعيد رسم الحدود الأخلاقية بما لا يترك مساحات رمادية للانتهاكات.
تطبيق مفاهيم نظرية “الحرب العادلة” على الاستخبارات
تسمح “الحرب العادلة” باللجوء إلى القوة بحكم الضرورة وشرعية الحرب، وتوضع الضوابط على أساليب القتال لمنع استهداف المدنيين وتحقيق “التناسب” بين الهدف والأسلوب.
إذا استبدلنا الحرب بـالاستخبارات تظهر لنا ثنائية “شرعية الاستخبارات” التي تحدد الغايات المشروعة لجمع المعلومات السرية -حفظ الأمن القومي والكشف عن الجرائم الخطيرة- و”شرعية أساليب الاستخبارات” التي تقيد أساليب التجسّس والتنصّت بالاستناد إلى مبادئ “الضرورة” و”التناسب” وضرورة الفصل بين الخصوصيات المشروعة ومصادر المعلومات المحمية.
فبخلاف الحرب، ما زال التجسّس الاستخباري على المستوى الدولي بلا قانون ملزم رغم منع اتفاقيات الأمم المتحدة أي سلطة من التدخل في خصوصيات الأفراد إلا “بما يقتضيه القانون ويكون ضروريًّا لأسباب الأمن القومي أو منع الجريمة أو حماية حقوق الآخرين”.
بينما ركّزت الاستراتيجيات الوطنية الحديثة على الأولويات الآنية: فقد حددت استراتيجية عام 2015 في بريطانيا الإرهاب وأمن الدولة والتحديات الإلكترونية كمحفزات لتوجيه عمل جهاز الأمن الداخلي، بينما منح قانون الأمن القومي الأمريكي لعام 1947 وكالة الاستخبارات المركزية حق “تنسيق وتقييم المعلومات المتعلقة بالأمن القومي”.
من خلال تأمل مفهوم “من الحرب العادلة إلى الاستخبارات العادلة”، نستحضر إرثًا عتيقًا من أخلاقيات الحروب في محاولة لإسقاطه على أجهزة الاستخبارات الديمقراطية كي تعمل في فضاء قانوني وأخلاقي منضبط، يسمح لها بالدفاع عن المجتمع دون الخروج عن قيمه ومبادئه الأساسية.
تسعى الدول لمنع الجريمة وتصوغ أجهزة إنفاذ القانون استراتيجيات استباقية لتفاديها قبل وقوعها، فتلجأ الشرطة إلى تجنيد عملاء مدرَّبين داخل العصابات الإجرامية على المدى الطويل، وتستخدم أجهزة تتبع دقيقة وتنصّت إلكتروني متطور. وتطلب أجهزة الأمن من مجتمع الاستخبارات دعم عملياتها في مواجهة الجريمة المنظمة تزامنًا مع مواجهة الحركات الجهادية واعتماد بعضها على العمليات السيبرانية، ما يزيد من تشابك عمل الشرطة والاستخبارات.
اقتضى هذا التقارب خضوع أجهزة إنفاذ القانون لأُطر أخلاقية شبيهة بتلك التي تفرض على المخابرات: التناسب، والضرورة، واحترام الخصوصية حتى لمن لا يشكلون هدفًا مباشرًا. كما حظرت القوانين استخدام قدرات الاستخبارات لصالح أي حزب سياسي أو منفعة شخصية، وحددت فئات تستحق خصوصية مضاعفة مثل النواب ورجال الدين والمحامين والصحفيين ومصادرهم. وبذلك بات لدى الدول الديمقراطية اللبنات الأولى لتحديد أولويات الاستخبارات، ووضع قيود أخلاقية على أساليب عملها.
تشتمل مفاهيم “الحرب العادلة” على العناصر التالية: أن يكون القتال لنوايا سليمة، وأن يهدف إلى غايات عادلة، وتقييد حجم الخسائر بقدر ما يتحقق به الهدف، والتمييز بين المقاتلين والمدنيين. وعندما نطبّق هذه العناصر على الاستخبارات، تبرز لدينا سبع دعائم: سبب عادل يُعلَن بوضوح في الوثائق السياسية، نية سليمة تبتعد عن الأجندات الخفية، تناسب يمنع الانزلاق إلى مراقبة وتجسس روتيني واسع، سلطة صحيحة تُحاكَم أمام المسؤولين، فرصة معقولة للنجاح لتجنب العمليات العشوائية، التمييز الدقيق لحماية الأبرياء، وضرورة الاقتصار على الوسائل الأقل انتهاكًا للخصوصية ما أمكن ذلك.
ولأهمية معيار “النية السليمة”، نجد أن الخبراء قد يختلفون في اعتبار الخداع وسيلة شرعية في الحرب والاستخبارات، لكنهم يتفقون على أن الدوافع يجب ألا تشمل أهدافًا شخصية أو سياسية. وفي المملكة المتحدة، دفعت تسريبات مكتب الاتصالات البريطاني GCHQ إلى فصل موظف تورط في البحث الممنهج عن بيانات شخصية لا علاقة لها بعمله.
ويقوم مبدأ “التناسب” في العمل الاستخباراتي على الموازنة الدقيقة بين الأضرار المحتملة التي قد تنشأ عن عملية سرية -مثل انتهاك خصوصية أبرياء أو تعريض عائلات العملاء للخطر- من عدمها، فلا يكفي تقدير المخاطر في الحاضر فحسب، بل يجب تقدير ما قد يحدث غدًا إن لم تُنفَّذ العملية. فالاستخدام الصحيح للوسائل المتوافرة لمواجهة تهديد كبير قد يبرر التنصت على حجم كبير من الاتصالات الرقمية، فيما قد يستنزف ذات الأسلوب جهدًا مفرطًا إذا استُخدم للتصدي لعصابة تسرق الدراجات.
والتدقيق القانوني لهذه الموازنة لا يقتصر على مطابقة الإجراءات مع نصوص القانون فحسب، بل يشمل التأكد من أن ما يقدمه القانون من ضمانات كافٍ للحماية من الانتهاك. ولهذا، تتعاظم سلطة التفويض القضائي والتنظيمي كلما ازدادت حساسية الأسلوب التدخلي للاستخبارات، ويتطلب الأمر عادة مراجعة أصحاب مستوى رفيع في الحكومة أو القضاء قبل الإذن بأي عملية.
أما “السلطة الصحيحة” فتعني أن النشاط الاستخباراتي يجب أن يخضع لنطاق قانوني مُعلَن، قريب لفهم المواطنين لا أن يكون تعسفيًّا وفق نزوات السلطة التنفيذية. ولكن هذا الاتساع في النصوص القانونية يتصادم مع السرية اللازمة لنجاح المهمة الاستخبارية، لذا فعلى الضابط أن يوازن بين الانفتاح الكافي أمام المفوضين والنواب وخطر إفشاء السرية وفشل الخطة.
ولن يكتمل الامتثال الأخلاقي دون “فرصة معقولة لنجاح” العمليات، وهو مبدأ معاكس لـلعشوائية القائمة على مراقبة واسعة بلا هدف محدد. فالتخطيط يُفترض أن يستند إلى تقدير واقعي لنتائج كل خطوة، لا إلى أمل ضئيل في العثور على أدلة بعد فحص مئات الآلاف من الاتصالات.
أما مبدأ “التمييز” فيستند إلى قدرة الأداة المستخدمة على التفريق بين ما يتصل بالاستخبارات الحقيقية للأفراد المطلوبين وما هو شائع لدى العموم، وهو ما يتطلب خوارزميات تصفية دقيقة للبيانات أو وعي بشري لحذف المعلومات غير اللازمة.
وأخيرًا فإن ضباط المخابرات مطالبون بتحقيق مبدأ “الضرورة وضبط النفس” حين تقع على عاتقهم مسؤولية اختيار الوسيلة الأقل انتهاكًا للخصوصية لتحقيق الهدف الذي يريدونه، فإما استخلاص المعلومة من المصادر المفتوحة أو التعاون مع القضاء للحصول عليها، لا المسارعة إلى الأساليب الأقل إنسانية ما دام هناك سبيل آخر. ولكن هذا الإسقاط لمفاهيم نظرية “الحرب العادلة” على عمل الاستخبارات تعترضه طبيعة الاستخبارات كنشاط دائم يتطلب لغته الأخلاقية الخاصة، وليست حالة طارئة كالحرب.
ولأن حماية الأمن القومي والتحقيق في الجرائم الخطيرة يضفيان شرعية واسعةً على عمل أجهزة الاستخبارات، إلا أن هذا التعميم لا يوضح متى ولماذا تُشنّ الحملة الاستخبارية؟ وما الحدود الأخلاقية لأهداف الاستخبارات؟ وكيف نقيّم الضرورة والتناسب مع افتقارنا إلى تعريف دقيق للأمن القومي أو لمخاطر محددة؟
فالفئات التي تُعدُّ “أهدافًا مشروعة” تأتي من تصورات نسبية لمصالح الأمن القومي تتغيّر من دولة إلى أخرى، ولذا يجب صياغة إطار يحدّد كيف يجب أن يجري العمل الاستخباري لتأسيس “شرعية السلوك الاستخباري”.
وتطبيق مبادئ “تخفيض الأضرار الجانبية إلى حدها الأقصى” و”التمييز والضرورة” على الاستخبارات يُعقّده وجود “المقاتل” و”المدني” في المجتمع نفسه. فالمستهدفون يعيشون بين المدنيين ويصعب في العمل السري تحديد خطوط واضحة بين الجانبين. كما أن السرية والتخفي يحولان دون تحقيق مساءلة حقيقية، ما يتيح لأجهزة الاستخبارات العمل بـ “التمييز” أو “التناسب” شكليًّا مع إلغائهما عمليًّا.
كما يحتاج مبدأ “الضرورة” في الاستخبارات إلى ضبط دقيق لكونه يحول حالات الطوارئ إلى قواعد دائمة، حيث لا يحدد متى تسمح أهمية المعلومة الأمنية بتجاوز خصوصية الأفراد.
في ضوء هذه التعقيدات، نحتاج لصياغة إطار أخلاقي محكم للاستخبارات بلغة خاصة تعالج “التمييز” داخل البيئة المدنية، و”السرية” بوصفها عائقًا أمام المساءلة، و”الضرورة” بقصرها على أهم التهديدات الفعلية، و”الرقابة” بكونها أداة لضبط هذه المبادئ عمليًّا. فقط بهذا الأسلوب المتماسك يمكن للديمقراطيات أن تضمن أن عمل مخابراتها لا يتجاوز “الحافة الأخلاقية”، لا بالاكتفاء بالقول “إنه قانوني”.
بالنسبة لمفهوم “الملاذ الأخير”، فلا يعني الانتظار لاستنفاد كل الخيارات قبل جمع المعلومات السرية عن تهديد وشيك، إذ إن أغلب المعلومات الأمنية الحاسمة لا تُمنَح طواعية، والاستخبارات بطبيعتها استباقية. وهكذا تتبدد فاعلية “الملاذ الأخير” كمعيار أخلاقي مناسب لجمع المعلومات، لأنه يعني بذلك تأخر اللجوء إلى التجسس تأخرًا كارثيًّا.
يقترح ديفيد أوماند استبدال المصطلح بفكرة “الضرورة” وحدها عبر التدرج التصاعدي في اعتماد خيارات أخلاقية أقل انتهاكًا للخصوصية والحصول على تفويض ملائم لكل عملية خاصة. من زاوية أخرى، يرى مارك فايثيان أن ضبط “الضرورة” داخليًّا غير كافٍ، بل يجب إدراك أبعادها الدولية: فكل إجراء استخباري يثير قلق الدولة المستهدفة وقد يحفّزها على تعزيز قدراتها.
على الصعيد الدولي، يُفضي التمييز القانوني بين الداخل والخارج إلى تفاوت في حماية الحقوق وفهم مختلف لـ “الضرورة” و”التناسب” في جمع المعلومات، ما يعقد جهود تأسيس أطر أخلاقية عالمية لكون مفهوم الأمن القومي محكومًا بمرجعية وطنية تتأثر بالثقافة السياسية والبيئة الاستراتيجية لكل دولة.
في سياق الحديث عن الاستخبارات الخارجية، نجد أن ظاهرة “الحرب الهجينة” وسّعت مفهوم الأهداف الاستخباراتية ووظائفها، وأجبرت وكالة الاستخبارات المركزية -مثلًا- على التحول من مجرد تحليل المعلومات إلى استهداف شبكات الجهاديين وقادتهم في الخارج بشكل مباشر.
اقتضى هذا التحول فصلًا بين أخلاقيات العمل الاستخباري -كيفية جمع المعلومات وتحليلها- وما يسمح باستخدام القوة ضد أهداف خارجية، كـ “الضرورة” و”التهديد الوشيك” و”التناسب”.
يقترح أوماند أن تُبنى شرعية الأهداف الاستخبارية على متطلبات حكومية محددة تُعتمد بعد نقاش عام، لا على وثائق سرية تصدرها الاستخبارات، ليدرك قادة الأجهزة بوضوح الحدود التي رسمها القانون لهم ومطالب المجتمع الديمقراطي.
تجدر الإشارة هنا إلى التمييز بين “شرعية الاستخبارات” و”شرعية أساليبها” في طبيعة صنع القرار: فالأول يجسد العقد الاجتماعي عبر قوانين وإرشادات منشورة تحدد أهداف جمع المعلومات ومبرراته، بينما الثاني يتعلق بتفويضات سرية وتنفيذية توجه العمليات اليومية. وبذلك يستمد عمل الاستخبارات شرعيته من القانون والنقاش العام معًا، ولا يُختزل إلى مجرد موافقة صورية على قانونية العمل.
تُظهر النقاشات حول مبدأ “الملاذ الأخير” محدوديته في السياق الاستخباراتي؛ فالطبيعة الوقائية للعمل تتطلب جمع المعلومات مبكرًا، ما يصطدم بتأويل الحرب العادلة لمبادئ مثل الضرورة.
ختامًا، فإن هذه المفاهيم ليست قائمة جامدة، بل أدوات للتفكير الأخلاقي، تساعد أجهزة الاستخبارات على موازنة خياراتها في السياقات الاستراتيجية والتكتيكية. ومع ذلك، يبقى العمل مستمرًا لتكييف هذه المبادئ مع واقع الاستخبارات السرية وتحدياتها الخاصة، مع احترام التنوع الثقافي والاستراتيجي بين الدول.
ضوابط استخدام المصادر البشرية
أثناء السعي للحصول على معلومات قيمة، قد يتعرض المصدر البشري ومن حوله لأخطار جسيمة وتجاوزات تبدأ من الخداع وقد تصل إلى حد التضحية بالمصدر، فكيف يمكن توظيف المصدر البشري للحصول على المعلومات دون ارتكاب انتهاكات كهذه؟
تنزع أجهزة الاستخبارات نحو التوظيف المفرط للسرية والعنف المحتمل للحصول على المعلومات، وهو ما قد يتحول إلى تواطؤ فاضح في الانتهاكات الممارسة والتغاضي المتعمد عنها، كما في اختراق وحدة أبحاث القوة (FRU) التابعة للاستخبارات العسكرية البريطانية لجمعية الدفاع الأيرلندية (UDA).
وفي المقابل، يُحسب للجهات الاستخباراتية التي زرعت عملاء داخل الجيش الجمهوري الأيرلندي (PIRA) نجاحها في إحباط تهريب أسلحة ليبية عام 1987، ما يوضح ثنائية عمليات الاختراق البشري: فعالية استراتيجية تهدر معها القيم الإنسانية ما لم يُصاحبها إشراف أخلاقي وقانوني حازم.
فخطورة الأمر لا تتوقف عند مجرد نقل المعلومات، بل تمتد إلى الخداع الممنهج والتضحية بحياة الأفراد من أجل ضمان استمرار تدفق أسرار المستهدف. فحين شكّت قيادة الجيش الجمهوري الأيرلندي في وجود عملاء بين صفوفها، شكلت “فرقة التصفية” الداخلية التي اعتبرت أي مشتبه به تهديدًا لأمنها، فاستجوبته وأصدرت حكمها غالبًا بالإعدام، ما أودى بحياة الكثير من الأبرياء.
بدورها استطاعت “وحدة أبحاث القوة” زرع عميل لها داخل فرقة التصفية نفسها، ولحماية هذا العميل وإبعاد الشبهة عنه تورطت الوحدة في جرائم قتل.
إن تجنيد المصادر البشرية لا يقوم على مبادئ نبيلة، بل على استغلال أضعف العناصر -عبر النساء أو المال أو الرغبة في الانتقام أو حتى الإكراه بعد الاعتقال- ما يجعلهم وسائل لتحقيق غايات الدولة لا أهدافًا قائمة في حد ذاتها، وهو ما يتعارض مع مبدأ تحريم استخدام الإنسان كمجرد وسيلة.
وفي مثال آخر، تسلل ضباط وحدة التظاهرات الخاصة (SDS) البريطانية إلى الحركات الاحتجاجية عبر تبنّي مظهرها وثقافتها، بل أقدم بعضهم على إقامة علاقات جنسية طويلة الأمد وأنجبوا من خلالها أطفالًا ما ولّد شعورًا بالخيانة العميقة، واعترفت قيادة شرطة لندن بإساءة استخدام السلطة ووقوع “انتهاك للحقوق الإنسانية لهؤلاء النسوة”.
تظهر دراسة تجنيد المصادر البشرية السرية إلى أن أبسط أشكال التعاون مع ضباط الاستخبارات تنطوي على استغلال مبطن للإنسان، سواء عبر الوهم الذي يقدمه المتسلل أو عبر إغراءات جنسية ومالية أو حتى التهديد بعد الاعتقال. كما تكون دوافع بعض المجندين مجرد الإحساس بالانتماء إلى “أسرة” الاستخبارات والرغبة في الانتقام، بينما قد يُستخدم الإكراه والسّرية لضمان إخضاعهم. وهذه العلاقات تعامل البشر كوسيلة لا غاية، ما يضعهم تحت ضغوط يصعب عليهم الانسحاب منها ويعرّضهم لخطر النبذ من محيطهم أو السجن أو القتل حال انكشاف أمرهم.
في المقابل، يطرح البعض مفهوم “نقل المخاطر الأخلاقية” حين تقلل عمليات الاستخبارات -رغم كلفتها الأخلاقية- من أخطار أكبر لاحقًا. ففي أواخر الحرب العالمية الثانية، طبّق جهاز MI5 أقسى أشكال “نقل المخاطر الأخلاقية” عبر عملية “القوس والنشاب- Crossbow” حين أوهم أجهزة الاستخبارات الألمانية بأن صواريخ V-1 d يسقط معظمها في شمال لندن، فحوَّلوا إطلاقها جنوبًا حيث كثافة سكانية أقل، فأنقذوا بذلك آلاف الأرواح، في عملية خداع استخباري قائمة على وعيٍ أخلاقي بارد ومدروس.
اليوم يخضع توظيف المصادر السرية في المملكة المتحدة لإطار قانوني مدوّن يحضّ وكالات الاستخبارات على إشراف قضائي من مفوَّض الخدمات الاستخباراتية، وإشراف برلماني من رئيس مفوضي المراقبة للشرطة. وعند إدارة عملاء محليين، نشر جهاز الشرطة “مدوّنة أخلاقية” بعد فضائح وحدة التظاهرات الخاصة (SDS)، تشترط على أي ضابط متخفي أن يُسائل نفسه: هل قراري يتماشى مع مدوّنة الأخلاق؟ وهل أستطيع الدفاع عنه أمام المشرفين والجمهور؟
من هذا نستخلص أن المعضلات الأخلاقية في تجنيد العملاء السرّيين لا تُحلّ بقواعد جامدة، بل بإطار متكامل يتضمَّن: اختيارًا دقيقًا لاكتساب القيم الأخلاقية للضباط، وتدريبًا يعزّز حسَّ التمييز والتناسب والضرورة، وإشرافًا فعّالًا ومراجعات دورية لمدى الحاجة إلى استمرار المهمة أو إنهائها فورًا فيما لو تجاوزت الحدود الأخلاقية. في غياب هذا المزيج من الضوابط الصارمة والمرونة الأخلاقية، تُصبح الاستخبارات وسيلة لانتهاك المبادئ التي وُجدت لحمايتها.
على صعيد آخر، نجد ثغرة في محاولات جمع المعلومات التي افتقدت للاحترافية والضوابط القانونية، فالاستخبارات البشرية تقوم على علاقة بين ضابط الاستخبارات والعميل ما يجعلها عرضة للهفوات البشرية واستغلال الثقة. لذلك، تحرص الأجهزة المحترفة على تجنيد العملاء عبر ضباط خارج سلسلة القيادة التشغيلية وأن تُراجع تقاريرهم جهات مستقلة لضمان الكفاءة والتصدي لمحاولات الخداع.
ومن هنا يظهر التزام ضابط الاستخبارات بالتعامل مع احتمال تعرّض العميل أو أسرته للخطر، محافظًا على وعيه الأخلاقي تجاه إنسانية العميل كغاية لا كوسيلة. ورغم أن بعض التلاعب بدوافع العميل أمر لا مفر منه، فإن الاحترام والالتزام بالواجب تجاهه يثمر عمليًّا: فالعملاء المتحمسون يقدّمون معلومات موثوقة أكثر من أولئك الذين يجري ابتزازهم، بينما تلعب سُمعة جهاز الاستخبارات في حفظ أمن العملاء دورًا في التجنيد.
الاستخبارات الرقمية وجمع البيانات
ينطلق هذا الفصل من الإقرار بأن التطور المتسارعة في مجال المعلومات ووسائل الاتصال عبر الإنترنت والأجهزة المحمولة أطلق ثورة في مجال الاستخبارات، فتحت الباب أمام فرص غير مسبوقة لجمع معلومات دقيقة عن الأفراد والأنشطة. لكن سهولة الوصول إلى هذه البيانات واستغلالها بسرعة يثير تساؤلات أخلاقية جوهرية تتعلق بالحق في الخصوصية وحماية المعلومات الشخصية وحرية التعبير في مواجهة محاولات السلطات تقييد المحتوى الرقمي، لا سيما ما تنشره التنظيمات المعادية لهذه الأنظمة أو المتعاطفين معها.
ومع تصاعد قدرة شركات الإنترنت على جمع كم هائل من البيانات الشخصية لاستخدامها في التسويق، تنامت فُرص تتبع الأفراد عبر هواتفهم المحمولة أو الأجهزة المرتبطة بالإنترنت، كما استغل الجهاديون والعصابات الدولية نقاط الضعف في هذه البيئة الرقمية.
نشأت هنا أولويات متضاربة على ثلاثة مستويات: فبينما يطالب المدافعون عن الحريات المدنية بتعزيز التشفير واتباع قوانين حماية بيانات صارمة، تحذر أجهزة الأمن من أن هذه الإجراءات تحرمهم من إمكانية كشف الجرائم الإلكترونية وتتبع المطلوبين. وفي الوقت نفسه، ترى أجهزة الاستخبارات في تحليلات البيانات الضخمة فرصة لتعزيز الأمن القومي سواء بدعم العمليات العسكرية أو بحماية البنى التحتية الحيوية أو المساعدة في تتبع شبكات الجريمة المنظمة.
ولكي تثبت الدولة جدارتها بثقة مواطنيها، يتعين عليها اتباع طريقة “الإشباع الكافي” في صنع القرار عبر تبني تدابير تضمن الحقوق الأساسية كافة دون إسقاط حق لصالح الآخر، فالأمن والخصوصية كلاهما ضرورة إنسانية وحق لا يمكن تجاوزه.
وإلى جانب اعتراض الرؤوس والاعتراض المباشر للمحتوى، يتاح أيضًا اقتحام أجهزة الحاسوب والهواتف عبر زرع برمجيات خبيثة، أو عبر التلاعب بالمعدات محليًّا، أو الاعتماد على تقنيات تحليل البيانات لانتزاع أنماطٍ عابرةٍ لقيود الهواء أو الكابلات. وقد أظهر هذا المزيج من الوسائل أن الفضاء السيبراني صار ساحة استخباراتية بامتياز، لا أقل خطرًا أو تأثيرًا من ميادين الأرض والبحر والجو.
لا يقدم قانون أي دولة حقًّا مطلقًا في الخصوصية؛ بل يقرّ بضوابط تسمح بتوازن ضروري بين سرّية الأفراد وحماية المجتمع، كما تنص المواثيق الحقوقية العالمية. ومن هنا يظهر دور “مبادئ العدالة الاستخباراتية”، المستمدة من إطار الحرب العادلة: إذ يجب أن تتوافر نية حقّة لدى من يلجأ إلى المراقبة، وأن تمارس السلطة المناسبة عبر موافقة قضائية أو برلمانية قبل تفتيش البيانات الرقمية، وأن يكون التدخل متناسبًا مع حجم الخطر المراد تجنّبه.
في عامي 2014 و2016، تلقت محكمة الاستئناف البريطانية دعاوى ضد وكالة الاتصالات البريطانية GCHQ، ورغم كونها لم تنكر مشروعية نشاط الاختراق الرقمي فإنها اتهمت الحكومة بعدم الامتثال لحكم القانون لإخفاقها في شرح كيفية تطبيق الإطار القانوني المعقد وضماناته. ونتج عن ذلك “قانون سلطات المراقبة 2016” الذي حصر جميع أشكال الاستخبارات الرقمية تحت سلطة واضحة، وحدّد بالتفصيل ما يمكن جمعه وكيفية الاحتفاظ بالبيانات والضمانات الموجودة، كما اتبعت الولايات المتحدة إجراءات مماثلة بعد تسريبات سنودن.
إن تحقيق الأمن الرقميٍ الفعال غير ممكن دون تنازل متبادل بين السلطة والشعب، فتخضع السلطة لرقابة قضائية وبرلمانية ويتنازل المواطنون عن جزء من خصوصيتهم لأجهزة الاستخبارات لحماية الأرواح.
هذا التوازن بين ضمانات الحريات والقدرات الاستخبارية الرقمية المتقدمة يتطلب إطارًا رقابيًّا قويًّا، يقوم على سلطة قضائية مستقلة تصدر أوامر الاختراق، ونظام رقابي برلماني يفصح عن نطاق الصلاحيات دون التفاصيل الفنية التي تكشف أساليب العمل، ومبادئ واضحة تتناول ضرورة وحجم وتناسب الاعتراض، وآليات شفافة لمراجعة الاحتفاظ بالبيانات ومدة تخزينها.
ثمة إشكالية تتعلق بـ “ربط النقاط”، حيث يميل المحلل إلى استنباط معانٍ خفية من مجرد تراكم بيانات عادية، فالعقل البشري قادر على إنتاج أي صورة ذهنية من أي مجموعة نقاط متراصة، ما يعرّض مواطنين أبرياء للخطر، وهو ما يكرس الحاجة إلى رقابة دقيقة تمنع إساءة تفسير السلوك الطبيعي.
ضوابط استخدام المعلومات الاستخبارية
يبدأ هذا الفصل من منطلق أن المعلومات السرية تضاعف قوة الدول، فهي تتيح رصد الخصم قبل أن يكشف أوراقه فتسارع وتيرة التفاوض وتختصر مسارات الدبلوماسية العلنية البطيئة. لكن ماذا لو تحولت أجهزة الاستخبارات السرية من أدوات ردع ومعلومات إلى أدوات غش وخداع تحت مظلة المصلحة الوطنية؟
تبدأ أخلاقيات استخدام الاستخبارات السرية عبر عزل العمل الاستخباري عن التوظيف الاستراتيجي للدول في الحروب أو السياسات الخارجية. وبما أن العمل الاستخباراتي صار أكثر توجهًا نحو “الكشف والتحديد”، لا سيما عبر الطائرات المسيرة التي حلّت محل الرصد التقليدي- فيمكننا تطبيق مبادئ “الحرب العادلة” مباشرة على “التنفيذ المباشر” المبني على الرصد الاستخباري.
في صميم هذه الديناميكية يبرز دور صناع القرار، الذين يتسلمون تقارير المحللين ويتخذون القرار بالفعل أو عدمه. ولذا، على هؤلاء القادة مراجعة “المصدر” أولًا والتأكد من موثوقيته وكشف كيفية استخراج المعلومة دون تعريض العميل السري للخطر، ثم موازنة قيمة الفعل مع درجة المخاطرة الأخلاقية التي قد تبلغ حد التسبب في كشف سرّ أو إلحاق الأذى بالمدنيين.
في بداية الحرب الباردة، جيشت بريطانيا عبر الخداع الرأي العام ضد نفوذ الشيوعية الدولية، حيث جندت المثقفين ورصدت المعارضين سرًا. ومع التقدم التكنولوجي، برزت الطائرات المسيرة الأمريكية التي أثارت الجدل حول قتل الجهاديين عن بُعد، واغتيالات العلماء النوويين الإيرانيين.
واختلطت في هذه العمليات المعايير الأخلاقية بالضرورات الأمنية، فتورطت أجهزة الاستخبارات بداية بالعمل الدعائي البسيط وتمويل الجماعات السياسية الصغيرة، ثم تصاعد الأمر إلى حملات التضليل السوداء وإمداد أحزاب معارضة حول العالم بالأسلحة سرًّا، وصولًا إلى اغتيالات قادة دول وجماعات في الخارج وتنظيم انقلابات واستخدام قوات خاصة في حروب سرية.
يميز القانون الأمريكي بين العمليات “السرية” والعمليات “القابلة للإنكار”، ويُلزم بالحصول على توقيع الرئيس على أمر تنفيذي لكل منهما مع إخطار لجان الرقابة في الكونغرس خلال 48 ساعة. وفي بريطانيا، يشترط القانون موافقة وزير الخارجية على أي عملية استخبارية خارج الحدود، لكن لا توجد سلطة قضائية كما في لجان الكونغرس الأمريكي ولا أدوات رقابية برلمانية مماثلة.
في المقابل، تقلصت أهمية الإنكار الرسمي -“لا نؤكد ولا ننفي”- نتيجة تطور الإعلام العالمي والانترنت ما أفقد الحكومات القدرة على إبقاء عمليات كبرى سرية تمامًا، ما دفع أجهزة الاستخبارات إلى الدفاع عن شرعية برامج مثل الطائرات المسيرة التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية. وفي هذا السياق، جرى استهداف قيادات جهادية بعد تشخيص أهداف وفق ربط نقاط وسلوكيات وأوصاف لا وفق تشخيص دقيق، ما دفع لإصدار أحكام قانونية حول حق الدفاع عن النفس ووضع إطار قانوني لـ “الحرب على الإرهاب”.
حتى بريطانيا واجهت ضغوطًا لشرح استهداف مواطنين بريطانيين في سوريا والعراق، فبررت الحكومة ضربات طائراتها المسيرة ضمن مشاركة عسكرية قانونية في العراق بناءً على طلب حكومة بغداد ورفعت إلى مجلس الأمن مبدأ الدفاع المشروع في مواجهة التنظيمات الجهادية.
هذه الأمثلة تبيّن أننا أمام مفاضلة: سرية تستدعيها الضرورة، وأخلاق تحكم متى وكيف نستخدم المعلومات السرية، والحل يكمن كذلك في إطارٍ يحمي الحرية ويقرّر مسبقًا صلاحيات العملية ويراقبها، وذلك من خلال:
- أوامر قضائية أو وزاريّة واضحة لكل عملية خارجية.
- رقابة مستقلة برلمانية وقضائية تمنع التورط في انتهاك.
- مراعاة مبادئ السلطة المشروعَة والنية السليمة والضرورة الملحة والتناسب في الوسائل.
- شفافية محدودة تكشف نطاق الصلاحيات دون المساس بفعالية التنفيذ السرّي.
تنقل هذه الآلية موازنة القرار الأخلاقي من المحلل الاستخباري إلى صانع القرار الذي يقرر متى وأين تُنفذ العملية. وهنا يبرز “ضبط المصدر” كشرط أساسي يستوجب من القائد مراجعة المعلومة مع الجهاز المسؤول للتأكد من موثوقيتها، ثم يوازن بين الفائدة الاستراتيجية ومخاطر الانكشاف والأذى الجانبي.
يرتكز الخطاب القانوني الأمريكي على معايير نزاع مسلح ووصف عمليات الاغتيال بكونها “قتل مستهدف” لكونه يستوفي خمسة شروط: وجود نزاع مسلح قائم، واستهداف فرد يشارك مباشرة في الأعمال العدائية، وعدم جدوى القبض عليه، وتوقيع مسؤول رفيع المستوى، وعدم انتهاك قواعد التمييز والتناسب. بيد أن هذه الضوابط طُرحت علنًا تحت ضغط متزايد مدفوع بحجم العمليات وتكرارها.
على الجانب البريطاني، تُشغَّل الطائرات المسيرة ضمن إطار عسكري واضح يحكمه قانون النزاع المسلح وفق ضوابط حساسة: فهي تساعد في تتبع الأهداف لمدة طويلة، وتتيح استشارات قانونية آنية، وتخضع للقيادة العسكرية المنضبطة، ما يدعم حس المسؤولية في إلغاء أو تعديل القرار حتى اللحظة الأخيرة. ومع ذلك، يواجه القادة معضلة أخلاقية في بُعد المسافة بين المشغّل والهدف والتي قد تفضي إلى نزع صفة الإنسانية عن المستهدفين وتحويلهم إلى “أهداف رقمية” على الشاشة، بعيدًا عن واقعهم الإنساني.
ويتجلّى تحدي أخير في عمليات اغتيال العلماء النوويين الإيرانيين عام 2010، حيث يبرز مبدأ الضرورة: فلا يكفي أن تكون بيئة العمل سرية أو تقنية الضربة دقيقة، بل يجب إثبات أن دور الضحية في برنامج الأسلحة النووية كان حاسمًا وأن اعتقاله مستحيل عمليًّا. فبالرغم من صعوبة تطبيق هذه المعايير، يبقى الالتزام الصارم بمبادئ النزاع المسلح هو الضامن الوحيد لاستمرار استخدام الاستخبارات السرية كأداة لحماية المجتمعات لا كأساليب مختصرة تؤجج العنف وتنتهك الحريات.
يبرز هذا الفصل أن “القتل المستهدف” يحتاج لتسلسل أخلاقي وقانوني دقيق يشبه درجات “سُلّم التصعيد”: فقبل الوصول إلى خيار اغتيال العلماء النوويين الإيرانيين كان لا بُدّ من استنفاد كل البدائل الأخرى، ومن بينها الهجمات السيبرانية التي أبطأت برنامج التخصيب، والدبلوماسية التي أوصلت إلى الاتفاق النووي عام 2015.
يكشف تحليل هذه الحوادث أن تطبيق مبدأ “الملجأ الأخير” لا يعني التوقيت اللحظي، بل التحقيق في غياب المسارات الممكنة الأخرى، وهي في هذه الحالة كالتفتيش والتعطيل السيبراني والعقوبات الدولية والحوار السياسي، قبل اللجوء إلى القتل المستهدف.
في المحصلة، يتبين أن العمليات الاستخباراتية المباشرة لا يمكن تكييفها بمعايير مؤقتة، بل يجب تقييمها حالة بحالة وفق مبادئ الحرب العادلة لضمان عدم اختزال السلطة السرّية إلى انتهاك دائم للقانون والمعايير الأخلاقية.
والدرس المركزي الذي يؤكده هذا الفصل هو أن الحكم الأخلاقي الذي يستحق الثقة لا يصدر من دائرة الاستخبارات المنعزلة، بل من التوازن بين العقلية الاستراتيجية للطوارئ والتزام راسخ بحقوق الإنسان.
الرقابة والمساءلة لتعزيز ثقة الجمهور
لا تُبنى الثقة في عالم الاستخبارات السرية بالاعتماد الأعمى، بل بالتثبت المتواصل من التزام الأجهزة بالقواعد. وتنطوي الرقابة الفعّالة على آليات داخلية تشجع القادة على تفعيل مدونات السلوك الأخلاقية، ومؤسسات خارجية تمنح البرلمان والجهات القضائية حق الاطلاع السري على أداء الأجهزة.
فقد أُنشئ منصب المفتش العام المستقل في وكالة الاستخبارات المركزية عام 1952 ليدقق بشكل دوري ومستقل ويكشف أي هدر أو فساد أو ممارسات غير قانونية، قبل أن يعطيه القانون عام 1989 ضمانات إضافية في التعيين والإعفاء. وفي عام 2004، قدّم تقرير المفتش العام لوكالة المخابرات المركزية أدلة فاضحة على استخدام أساليب استجواب قاسية بعد 11 سبتمبر ما أدى إلى مساءلة وزارة العدل وإلغاء البرنامج لاحقًا، في مثال واضح على قدرة الرقابة الداخلية على توجيه عمل الأجهزة ومساءلتها.
واختبارًا للمراقبة الخارجية، أحدثت الولايات المتحدة لجانًا في مجلسي الشيوخ والنواب وأخذت طابعًا دستوريًّا، حيث واجهت تحديات في استيعاب عمق الشؤون الاستخباراتية وتجنب التسييس، إلا أنها رسّخت مبدأ مساءلة القرار التنفيذي أمام البرلمان.
أما في بريطانيا فباتت جميع أجهزة الأمن والاستخبارات تضم أعضاء مستقلين يسهمون في كسر عزلتها السرية، وأسست لجنة الاستخبارات والأمن البرلمانية عام 1994 وعُزّزت عام 2013 بنقل تعيين أعضائها إلى البرلمان ومنحهم صلاحية الوصول إلى المعلومات السرية.
إن الثقة في أجهزة الأمن والاستخبارات تتجسّد حين تجتمع مدونات السلوك الداخلية الصارمة مع رقابة خارجية شفافة خاضعة للقانون، فتصبح السلطة قادرة على حماية الوطن من دون التخلي عن حقه في الخصوصية.
ويختلف النموذج الأمريكي عن الأوروبي في فصل السلطات: ففي الولايات المتحدة، يُلزَم الكونغرس بالاطلاع المسبق على النفقات والعمليات الكبرى ويُعدُّ شريكًا في صنع القرار ممثلًا للسلطة التشريعية ضمن الحكومة نفسها، بينما تقتصر رقابة اللجان الأوروبية على قرارات السلطة التنفيذية على المراحل اللاحقة دون مناقشتها مسبقًا حفاظًا على استقلاليتها في التقييم والنقد.
ولتتحقق الرقابة الفعّالة، تشترط الدول توفير الوقت الكافي لأعضاء اللجان لفهم أسرار العمل الاستخباراتي، وتجهيزهم بخبراء وموظفين متخصصين، وقيادة قادرة على تجاوز الانقسامات الاستخباري وتوفير بيئة آمنة وسرية للاطلاع على المستندات الحساسة. لكن شكوكًا أثيرت داخل مجتمع الاستخبارات حول قدرة اللجان البرلمانية السياسية على الحفاظ على السرّية الكاملة، إذ إن أي لجنة معرَّضة لضغوط سياسية قد تتهاون في حماية المواد المصنفة أو تضعف من مصداقيتها أمام الأجهزة.
تؤدي الرقابة القضائية دورًا مكملًا حين تصادق المحاكم على إجراءات المراقبة العميقة التي تتجاوز خصوصية الأفراد، وتعزّز ثقة الشعب استقلالية القضاء. لكن الإفراط في إشراك القضاة قد يبعد مسؤوليات التنفيذ عن السلطة، ويحول السياسة القضائية إلى سلطة تتجاوز اختصاص الرقابة القضائية.
على مستوى الأفراد، توفر أجهزة الاستخبارات الحديثة آليات “صمامات أمان” أخلاقية تشمل تدريبًا على الإشكالات القانونية والأخلاقية، ونشر مدونات سلوك واضحة، وتعيين مستشارين داخليين يستقبلون شكاوى الموظفين بسرية، إضافةً إلى دور المفتشين العامين وقوانين حماية المبلغين عن المخالفات، ويمكن للموظفين في بعض الأجهزة تسجيل اعتراض رسمي يُراجع مستقلًا.
ورغم ذلك، قد تدفع الخشية من العقوبات البعض إلى الكشف العلني عن الانتهاكات بدل اللجوء للقنوات الداخلية، فالرقابة منافسة بين أجهزة الأمن واللجان الرقابية والتوتر الذي قد يحصل بينهما يعد علامة على صحة الرقابة لا فشلها.
بعد تأسيس لجنة الاستخبارات والأمن (ISC) في بريطانيا بموجب قانون 1994، نجحت في عقدها الأول بكسب ثقة الأجهزة وتوسيع اختصاصاتها من مراقبة إدارة الأجهزة إلى متابعة النشاط العملياتي. لكنها في العقد الثاني واجهت انتقادات لعدم التحقيق في إخفاقات “الحرب على الإرهاب”، سواء في قضية أسلحة الدمار الشامل قبل حرب العراق أو في عمليات التعذيب، وبدا أنها تفتقر إلى الإرادة السياسية والموارد الكافية لدورها الرقابي.
حين أدركت الحكومة والأجهزة بنهاية 2012 أن الرقابة فشلت في استعادة ثقة الجمهور، قدمت اللجنة إصلاحات أُقرّت في قانون العدالة والأمن لعام 2013 وأصبحت مسؤولة أمام البرلمان مباشرةً، يمثّلها نواب يرشّحهم رئيس الوزراء بعد مشاورات الأحزاب، كما منحها القانون حق الوصول المباشر إلى المعلومات الضرورية مع الاعتراف رسميًّا بدورها في التحقيقات العملياتية.
غير أن تسريبات سنودن كشفت سريعًا أن اللجنة لم تعلم، أو لم تتحرك، إزاء مكتب الاتصالات الحكومية البريطانية GCHQ مع وكالة الأمن القومي الأمريكية NSA بموجب برنامج PRISM، فظهرت هشاشة الرقابة البرلمانية في غياب حق الإفصاح عن آليات التعاون المشروعة. وأدى الأمر إلى دعوى قضائية رفعتها منظمة Liberty قضت بإلزام الحكومة بالكشف عن الضمانات القانونية، ما مهّد لقانون صلاحيات المراقبة 2016 الذي وسّع متطلبات الشفافية.
يُشير مارك فيثيان إلى أن هذا المثال يسلط الضوء على أهمية تقديم ملخصات إحاطة فعالة للجان الإشراف وإشراك الخبراء في “حلقة السرية”، وتوفير الموارد الكافية لقراءة وتحليل ملفات الأجهزة السرية. فالإحاطات المغلقة دون إمكانية متابعة الأسئلة أو التشاور مع المستشارين تجعل الرقابة بمثابة ستار حماية للأجهزة أكثر منها سلطة فاعلة للبرلمان.
تنبثق من هذا الجدل أسئلة حاسمة عن طبيعة الرقابة على الأجهزة السرية في عصر التقنيات المعقدة: هل بات من الضروري دمج الخبرة الفنية بالخبرة السياسية في هيئات الرقابة؟ وهل ثبت فشل النموذج البرلماني في تكيّف قوانينه مع قدرات المراقبة الرقميّة المتطوّرة حتى بات لا يخدم المساءلة الفعلية؟ وهل آن الأوان لنقل الغالبية العظمى من مهمات الرقابة إلى القضاء المستقل؟
من وجهة نظر السلطة التنفيذية والأجهزة الاستخبارية، يهدف إشراك البرلمان إلى بث الثقة العامة في مقدرة الأجهزة على أداء مهامها بشكل مشروع وفعّال، لكن لجان الرقابة قد تواجه دافعًا للحفاظ على الثقة نفسها ما يولّد ضغطًا قد يمنعها من كشف إخفاقات أو تجاوزات أخلاقية.
كما يجدر التنبه إلى خطر انجذاب أعضاء اللجان إلى أجواء السرية والمعلومات الحصرية فيصبحون -بلا وعي- جزءًا من العالم الذي يفترض بهم مراقبته، ما يعكس التوتر الدائم بين مهام الرقابة وطبيعة أجهزة الاستخبارات السرية.
أما الإعلام ولجان التحقيق الخاصة فكان لهما دور رئيس في كشف الفضائح الاستخبارية قبل تدخل البرلمان، ما يشير إلى أهمية وجود آليات تكميلية تتجاوب سريعًا مع ما يُكشف من تجاوزات قبل أن تتمكن لجان البرلمان من العمل بفعالية.
من جهة أخرى، يجب التشديد على لجان الرقابة البرلمانية بأن لا تندفع سريعًا إلى إصدار الأحكام تحت الضغط الإعلامي الساعي إلى فضح الأسماء وإدانة المذنبين، كما لا ينبغي لهم أن يكتفوا بالتطمينات التي يقدمها جهاز الاستخبارات بأن “كل شيء طبيعي” قبل أن يجروا تحقيقًا معمّقًا يقنعهم بأن ما لديهم من معلومات كافٍ للإجابة عن الأسئلة المطروحة، وهذه المهمة لا يمكن إنجازها بلا كوادر خبيرة تعمّق البحث عن الحقائق.
حين وقوع حوادث استخبارية مفاجئة، تقيّم لجان الرقابة ما إذا كانت الأجهزة حددت البيانات اللازمة وأنشأت المصادر في الأماكن المناسبة وفق أولويات محددة، ثم جمعت المعلومات وفسرتها وأبلغت عنها بدقة لتصل التقارير في الوقت المناسب إلى صناع القرار، وبعد ذلك ينبغي أن يُفهم التقييم بوضوح فتقبل الجهات المعنية تداعياته وتتخذ القرارات المنطقية بناء عليه. غير أن هذه السلسلة من الخطوات المدفوعة بأهداف سياسية وأمنية متغيرة قد تحجب أمام المشرفين المختصين الخيارات البديلة التي لم تعتمد، فتحتاج الرقابة إلى التركيز على الخطأ في النظام المتبع لا على التقاطعات الظرفية.
ومع أن الرقابة الخارجية مهمّة فإن لها حدودًا في عالم الاستخبارات، فتتأثر بدرجة الثقة التي أثبتها عناصر الاستخبارات في الماضي. ولذا، تقوم لجان الرقابة بزيارات ميدانية تثبت من خلالها التزام الأجهزة بمدونات السلوك، فضلًا عن دور المفوضين القضائيين والمفتشين الداخليين في “الدائرة السرية”. لكن على لجان الرقابة الحذر من استغلال تلك الثقة سياسيًّا أو أن يتبنّوا موقفًا عدائيًّا فينخرطوا في لعبة صراع السلطة مع الاستخبارات.
خاتمة: نحو تجسس قائم على المبادئ
يتأكد من خلال هذا الكتاب أننا لسنا أمام مفارقة بلا حل بين الأخلاق والسرّية الاستخباراتية، بل أمام توترٍ لا مفر منه يجب إدارته بحنكة. فالدول الديمقراطية مطالبة بتوفير أمان لأفرادها يلازمه احترامٌ صارم للحقوق والحريات، مع الاعتراف بأن الوسائل الاستخبارية تحتاج إلى ضوابط أخلاقية لا تقل أهمية عن القوانين التي تحكمها.
إن الاختبار الأخلاقي الوحيد لأي عملية سرية هو استعداد المسؤولين عنها للدفاع عن قراراتهم أمام الرأي العام إذا انكشفت، فما كان قانونيًّا لا يعني تلقائيًّا أنه أخلاقي. ومن هنا كان إسقاط مفاهيم “الحرب العادلة” على عالم الاستخبارات بما يشكل نقلة نظرية أساسية، تقوم على تحقيق متطلبات الأهداف العادلة والنية السليمة والتناسب والسلطة الشرعية والضرورة والفرص المعقولة للنجاح والتمييز بين الأهداف والمواطنين الأبرياء، حتى يظل استخدام السرية سبيلًا لحماية المجتمع لا أداةً للظلم والتجاوزات.
على المستوى البنيوي، شهد العقدان الماضيان انتقالًا من نموذج “الدولة السرية” إلى “الدولة الحامية لشعبها” حين أصبح العقد الاجتماعي بين الحكومة والشعب واضحًا ومنصوصًا عليه في القانون، وهو ما قنن عمل الاستخبارات وأعطاه صلاحيات ضمن شروط ورقابة فاعلة. لكن هذا التحول لا يقتصر على الحدود القانونية، بل يمتد إلى واجبات المحللين الذين لا تقل مسؤوليتهم الأخلاقية عن مسؤولي جمع المعلومات؛ إذ قد يتسبب التأخر في الكشف عن هجمات إرهابية أو الإخلال بحقيقة معلومة بوقوع ضحايا. في المقابل، يقول مديرو الاستخبارات الحقيقة للسلطة دون تزييف التقديرات حفاظًا على نزاهة القرار السياسي.
لقد ثارت قضايا أخلاقية كبيرة في مجال العمل الاستخباراتي: من مخاطرة الجواسيس وعائلاتهم عند التعامل مع أهداف خطرة، إلى انتهاك خصوصية الملايين بواسطة التنصت الرقمي. ومن هنا يأخذ النقاش الأخلاقي أبعادًا جديدة تتعلق بالملفات الشخصية للمواطنين أو برسائل دعائية مضادة، وتتجاوز بذلك حدود أجهزة الدولة لتصل إلى شركات الإنترنت التي تبني اقتصادها على تسويق البيانات.
إن الأمن لا يتحقق على حساب قيم الحريات الأساسية، ولا تكفي القوانين وحدها لمنع التجاوزات، بل يتطلّب الأمر تأصيل المبادئ في ثقافة الأجهزة وقوانينها وتشكيل مراجعة نيابية وقضائية، كي تبقى أجهزة الاستخبارات دومًا في خدمة الدولة والمجتمع لا ندًا لهما.
وأخيرًا، تختزن قواعد البيانات التي تحتفظ بها الحكومات والشركات كمًّا هائلًا من المعلومات الشخصية، ما يهدد بفرض “استثناء عام” لقيود الخصوصية تحت عنوان حماية الشعب. فإذا لم تتسم آليات تخزين المعلومات وفرزها بالدقة الكافية فقد تتحول إلى مراقبة جماعية تقضي على حرية التعبير وتثني الناس عن التواصل الطبيعي فيما بينهم. لذا، يتعيّن إجراء حوار مسبق حول الحد الذي يُسمح عنده بانتهاك الخصوصية مع إدراك أن تعيين هذه الحدود سيبقى معضلة مستمرة تجمع بين القانون، والأخلاق، وحاجات الأمن القومي.
يبقى التوتر بين السرية والشفافية ركيزة أساسية في العمل الاستخباراتي، فمن جهة لا بُدّ من كشف الأطر القانونية التي تنظم أساليب المراقبة والاختراق ليتاح للمواطنين الموافقة الواعية عليها، ومن جهة أخرى يجب أن تبقى الأسرار المتعلقة بالمصادر والوسائل التقنية والبشرية سرية بالكامل لكي تظل فعالة في مواجهة المخاطر.
تقع مسؤولية إدارة هذه التوترات في المقام الأول على المستوى الوطني، لكن ثمة إمكانية لتبني منظورٍ دولي يروّج للمبادئ الأخلاقية نفسها. فالانتقال من السياسات السيادية بلا ضوابط إلى نموذج “العقد الاجتماعي” يمنح أجهزة الدولة السرية ترخيصًا ديمقراطيًّا تحت سيادة القانون، عبر نقاشات عامة وصحافة استقصائية وقانون يحدد الأهداف والضمانات. ويمكن لهذا النموذج أن يُصبح إطارًا لتوحيد الممارسات وتشجيع الحكومات على الالتزام بمعايير أخلاقية مشتركة.
عندما تُترجم هذه الأفكار إلى سياسات وطنية فإنها ستعزز قدرة مؤسسات الدولة على التعاون في مكافحة الأخطار والجريمة المنظمة عبر تبادل آمن للأدلة والمعلومات. وستظل علامة التميّز للاستخبارات في الدول الحرة هي سيادة القانون الخاضع للمراجعة الدورية، وضوابط أخلاقية راسخة، وآليات رقابية قوية، وصحافة حرة ترفع الغطاء عن أي تجاوز. فبذلك يمكن أن نشهد عصرًا جديدًا يضمن تحكّمًا ديمقراطيًّا فعّالًا في الأنشطة الاستخبارية السرية، ويشجع الدول التي لا يزال فيها هذا النشاط من ألغاز “الدولة العميقة” على الانفتاح والتشارك مع مواطنيها.
[1] منسق الاستخبارات والأمن في مكتب مجلس الوزراء البريطاني بين عامي 2002- 2005، وعضو لجنة الاستخبارات المشتركة سبع سنوات، ومدير وكالة استخبارات الإشارة البريطانية ونائب وكيل وزارة الخارجية لسياسات الدفاع في وزارة الدفاع. كما أنه أستاذ زائر في قسم دراسات الحرب في جامعة كينغز كوليدج بلندن وزميل فخري في كلية كوربوس كريستي بجامعة كامبريدج.
[2] أستاذ العلوم السياسية في قسم السياسة والعلاقات الدولية بجامعة ليستر في المملكة المتحدة.
[3] متعاقد سابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية.

